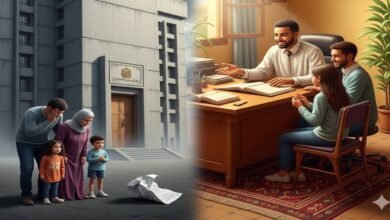المغاربة المقيمون بالخارج.. قوة معطلة تبحث عن تمثيل فعلي

ريف360- إسماعيل الخطابي
شكلت مسألة المغاربة المقيمين بالخارج، والتي غالبا ما يشار إليها بـ “مغاربة العالم”، محورا رئيسيا في الخطاب الرسمي والسياسات العامة بالمملكة المغربية. لقد تم الاعتراف بهذه الشريحة من المواطنين، التي يتجاوز عددها 5 ملايين نسمة وفق إحصاءات وزارة الخارجية، كقوة حيوية ورافد أساسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكسه حجم تحويلاتهم المالية السنوية. ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول مدى ترجمة هذا الاعتراف إلى شراكة استراتيجية حقيقية تتجاوز البعد الاقتصادي الصرف، لتشمل التمثيل السياسي الفعال والاستفادة المثلى من رأسمالهم البشري. إن المقاربة الحالية، رغم التقدم الدستوري، تبدو وكأنها تنظر إلى الجالية كـ”خزان” للعملة الصعبة والسياحة، متجاهلة قدرتها الهائلة على المساهمة في القرار السياسي والتنمية الشاملة. يهدف هذا التقرير إلى تحليل الفجوة بين الطموح الدستوري والواقع العملي، مع تسليط الضوء على الإمكانات المهدرة وتقديم توصيات عملية لتحقيق شراكة مواطنة متكاملة.
الإطار الدستوري والقانوني: طموح تمثيلي لم يترجم بعد
يمتلك المغرب إطارا دستوريا متقدما في مجال حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية. ومع ذلك، تكشف آليات التفعيل المعتمدة عن وجود فجوة عميقة بين النص القانوني والواقع السياسي، مما يعيق ترجمة الحقوق الممنوحة إلى تمثيل فعلي ومؤثر.
الحقوق الدستورية: ركيزة المواطنة الكاملة
تعتبر الفصول الدستورية الجديدة التي جاء بها دستور 2011 ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجالية كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني. فقد نص الفصل 17 بشكل صريح على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون “بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”. كما أتاح لهم إمكانية “تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”. هذا النص يشكل اعترافا غير مسبوق بحق الجالية في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع مواطني الداخل، مانحا إياهم حقا مزدوجا في الترشح والتصويت. علاوة على ذلك، شدد الفصل 16 على حرص الدولة على “حماية الحقوق والمصالح المشروعة” للجالية و”الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم”، بينما أكد الفصل 18 على ضرورة “ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة”. وأخيرا، عزز الفصل 163 هذا التوجه بإحداث “مجلس الجالية المغربية بالخارج” كهيئة استشارية مسؤولة عن إبداء آرائها حول السياسات العمومية التي تهم الجالية. هذه النصوص تعكس إرادة سياسية عليا لتأصيل العلاقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج على مبدأ المواطنة الكاملة.
آليات التفعيل: بين النص القانوني والواقع السياسي
في محاولة لتفعيل هذه المقتضيات الدستورية، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من الإجراءات والتحفيزات. وقد كشف وزير الداخلية عن وجود إطار قانوني وطني يضمن لمغاربة العالم الحق في التسجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة في مختلف الاستحقاقات على قدم المساواة مع نظرائهم في الوطن. كما تم توسيع آليات التسجيل ومنح إمكانية التصويت إما بالحضور الشخصي في المغرب أو عبر نظام الوكالة انطلاقا من بلدان الإقامة. وعلى صعيد الترشح، أكد الوزير أن القانون يتيح لأفراد الجالية التقدم بترشيحاتهم ضمن الدوائر الانتخابية داخل التراب الوطني.
ولتعزيز هذا الحق، تم خلال انتخابات 2021 إلزام الأحزاب السياسية بترشيح شخص واحد على الأقل من مغاربة العالم ضمن لوائحها الجهوية للاستفادة من الدعم العمومي. كما أقرت الحكومة حوافز مالية إضافية لفائدة الأحزاب التي تدمج مرشحين من الجالية في لوائحها المحلية للانتخابات التشريعية. هذه الإجراءات، وإن كانت تعكس إرادة رسمية لتشجيع التمثيلية، تظل قاصرة عن تحقيق تمثيل فعال، وهو ما يؤكده الوزير نفسه عندما دعا الأحزاب إلى “ترشيح أفراد الجالية في مواقع متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية، من أجل ضمان وصولهم الفعلي إلى مواقع التأثير وصنع القرار”.
رؤى متعمقة: الفجوة بين “النص” و”الممارسة”
إن التحليل الدقيق للوضع يكشف أن التحدي لا يكمن في غياب النص القانوني، بل في فعالية الآليات المطبقة والفجوة الكبيرة بين “النص” و”الممارسة”. هذا التناقض الجوهري يمكن تفسيره من خلال نقطتين أساسيتين.
أولا، غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأحزاب الوطنية. على الرغم من الحقوق الدستورية والتحفيزات الحكومية، فإن الأحزاب السياسية لم تظهر اهتماما كافيا ببرامجها تجاه الجالية. إن دعوة وزير الداخلية للأحزاب لتمكين المغاربة في الخارج من مواقع متقدمة، بدلا من إلزامها بذلك، يكشف أن الأحزاب تنظر إلى الجالية ككتلة تصويتية محتملة أو مصدر للحصول على الدعم المالي، لكنها لا تعتبرها أولوية في برامجها الانتخابية. تفضل الأحزاب الاعتماد على مرشحي الداخل الذين يمتلكون شبكات دعم محلية قوية، مما يجعل تمثيل الجالية شكليا وهامشيا.
ثانيا، مشكلة “التمثيلية” في ظل “غياب الدوائر الانتخابية المخصصة”. صحيح أن الدستور يسمح بالترشح على مستوى اللوائح والدوائر الوطنية، إلا أن غياب دوائر انتخابية خاصة بالجالية يترك هذا الحق “نظريا”. المرشح من الخارج يواجه صعوبة بالغة في التنافس مع مرشحي الداخل، الذين يتمتعون بوجود ميداني مستمر، وشبكات حزبية راسخة، وإمكانات مادية أكبر. هذا يختلف عن تجارب دولية ناجحة، اللتي خصصت مقاعد برلمانية محددة لمواطنيها في الخارج. هذا النهج يضمن تمثيلا فعليا ومباشرا للجالية في البرلمان، مما يضمن وجود أصوات مخصصة للدفاع عن مصالحها، وهو ما يفتقده النموذج المغربي الحالي.
من تحويلات العملة الصعبة إلى رأس المال البشري المهدر
ينظر إلى المغاربة المقيمين بالخارج غالبا من منظور “نفعي” بحت، حيث يعتبرون مصدرا حيويا للعملة الصعبة ورافدا أساسيا لقطاع السياحة. ورغم أن هذه المساهمة الاقتصادية لا يمكن إنكارها، إلا أن هذا المنظور يقلل من قيمتها الحقيقية، ويخفي حقيقة أن جزءا كبيرا من رأسمالهم البشري والمالي لا يتم استغلاله بالشكل الأمثل.
المساهمة الاقتصادية: أرقام تتحدث عن “قوة” لا يمكن تجاهلها
تعد تحويلات المغاربة في الخارج الرافد الاقتصادي الأكبر للمملكة، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد بلغت هذه التحويلات حوالي 11.7 مليار دولار في عام 2024، في حين وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. هذه الأرقام تؤكد أن الجالية المغربية ليست مجرد قوة اقتصادية، بل هي “دعامة أساسية” للنمو الوطني. لقد شكلت هذه التحويلات صمام أمان للاقتصاد المغربي، خاصة في أوقات الأزمات كجائحة كورونا، وساهمت بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات والإنعاش الاقتصادي.
“المساهمة المهدرة”: فجوة الاستثمار والنموذج الدولي
على الرغم من الحجم الهائل للتحويلات، فإن تحليل كيفية توزيع هذه الأموال يكشف عن إمكانيات هائلة مهدرة. تشير المعطيات الرسمية إلى أن 60% من التحويلات توجه لدعم الأسر، و30% تخصص للادخار، بينما لا تتجاوز نسبة الاستثمار 10% فقط. هذه النسبة منخفضة جدا مقارنة بنماذج أفريقية أخرى، حيث تصل نسبة الاستثمار من التحويلات في نيجيريا إلى 45% وفي كينيا إلى 35%. هذا التفاوت يؤكد أن التحدي ليس في حجم الأموال، بل في غياب الآليات الفعالة والبيئة الاستثمارية الجاذبة. وقد أشار الملك محمد السادس بنفسه إلى هذا الخلل، معتبرا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10%”.
رؤى متعمقة: من “هجرة الأدمغة” إلى “استنزاف رأس المال البشري”
لا يقتصر الإهدار على الجانب المالي، بل يمتد ليشمل الرأسمال البشري الذي يمثل قيمة مضافة لا تقدر بثمن. إن ظاهرة هجرة الأطر والكفاءات المغربية إلى الخارج، والتي تُعرف بـ”هجرة الأدمغة”، هي في جوهرها “استنزاف ناعم” للاستثمار العمومي. تصرف الدولة ميزانيات ضخمة على تعليم وتكوين الأطباء والمهندسين والباحثين، ثم تهاجر هذه الكفاءات إلى دول أخرى لتساهم في تنميتها، دون أن تتحمل تلك الدول أي مقابل مادي أو أخلاقي. هذا النزيف يؤدي على المدى القريب إلى نقص حاد في الكوادر الطبية والتقنية في المستشفيات والمقاولات المغربية، وعلى المدى المتوسط يضعف من تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرس التبعية التكنولوجية والعلمية للخارج.
إن البرامج الحكومية التي تهدف إلى “تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج”، مثل إطلاق قواعد بيانات أو تنظيم منتديات وملتقيات ، وإن كانت ضرورية، فإن طبيعتها تثير تساؤلا حول فعاليتها. تبدو هذه المبادرات وكأنها محاولة لإدارة “الخسارة” واستعادة جزء من الكفاءات بعد هجرتها، بدلا من أن تكون استراتيجية شاملة للتعامل مع “هجرة العقول” من جذورها عبر خلق بيئة عمل محفزة ومناخ ثقة يضمن لهم مسارات مهنية واضحة داخل الوطن. هذا التوجه “الرد الفعلي” يقلل من فعالية المبادرات، ويكرس النظرة القاصرة التي ترى في الجالية موردا يمكن استخدامه عند الحاجة، لا شريكا أصيلًا في بناء المستقبل.
معوّقات المشاركة: تحديات بنيوية تتجاوز الإطار القانوني
إن ضعف مشاركة الجالية في الحياة السياسية لا يعود فقط إلى الإطار القانوني، بل هو نتاج تحديات بنيوية تتجاوز الحقوق الممنوحة لتلامس الجوانب اللوجستية والإدارية والمؤسساتية، وحتى العلاقة غير المباشرة بين المواطن ووطنه.
التحديات اللوجستية والإدارية: العائق اليومي
يشكل العائق الإداري اليومي أحد أكبر أسباب النفور من المشاركة السياسية. يشتكي أفراد الجالية المغربية من تعقيدات الإجراءات الإدارية، وضعف الخدمات القنصلية، وبطء معالجة معاملاتهم، وغياب الكفاءة لدى بعض الموظفين. تتعدد الشكاوى من صعوبة تجديد الوثائق، وعدم وجود نظام دفع إلكتروني، وبطء التعامل مع ملفات الاستثمار. هذه التحديات لا تؤثر فقط على حياتهم الشخصية، بل تخلق لديهم شعورا بأن الدولة لا تقدرهم كأفراد، وأن العلاقة معها ليست قائمة على “المواطنة”، بل على “المنفعة”. فكيف يمكن لمواطن أن يشارك في بناء مستقبل وطنه إذا كان يعاني من أبسط الإجراءات الإدارية الأساسية؟ إن هذا التناقض يؤكد أن أي إصلاح سياسي يهدف إلى إشراك الجالية يجب أن يبدأ أولا بإصلاح إداري جذري يرقمن الخدمات ويجعلها أكثر فعالية وسلاسة.
التحديات السياسية والمؤسساتية: غياب الثقة والتهميش
تتجلى مشكلة العلاقة بين الجالية والمؤسسات المغربية في غياب الثقة المتبادلة. يشعر العديد من أفراد الجالية بأن أصواتهم لا تُسمع وأن مطالبهم لا تؤخذ بعين الاعتبار في رسم السياسات العامة. هناك غياب واضح لآليات تشاركية دائمة تمكنهم من التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار الذي يخصهم. وقد أكد أحد الفاعلين الجمعويين أن “الأساس هو بناء الثقة عبر الشفافية وتمكين الجالية من تمثيلية حقيقية داخل مؤسسات القرار”. كما يعبر بعض أفراد الجالية عن شعورهم بأنهم مجرد “رعية” وليست مواطنين كاملي الحقوق، وأن استثماراتهم غير محمية، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في المنظومة المؤسساتية.
رؤى متعمقة: التحديات الاجتماعية كمؤشر على التهميش السياسي
إن ضعف المشاركة السياسية للجالية ليس معزولا عن التحديات الاجتماعية التي تواجهها. فالجالية المغربية، التي عرفت تحولات عميقة بفضل التزايد المستمر لنسبة النساء وتعدد الأجيال ، تعاني من صعوبات كبيرة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية. ورغم وجود برامج حكومية لـ”التعزيز الهوياتي”، مثل تعليم الثقافة المغربية ، فإن هذه الجهود لا تخلو من انتقادات لكونها غير كافية لمواجهة تحديات الانغماس في ثقافات بلدان الاستقبال. إن هذا التهميش الاجتماعي والثقافي يعكس فشلا في بناء “علاقة مواطنة” شاملة. فإذا لم يشعر المواطن بالارتباط العميق بهويته، وبأن دولته تهتم به خارج نطاق دوره الاقتصادي، فإن مشاركته السياسية ستظل ضعيفة وغير مستدامة، بغض النظر عن الحقوق الممنوحة له.
تجارب دولية في تمثيل الجاليات والاستفادة من خبراتها
يمكن للمغرب أن يستلهم من تجارب دول أخرى نجحت في دمج جالياتها في الحياة السياسية والاقتصادية. تقدم هذه النماذج حلولا عملية يمكن أن تترجم الطموحات المغربية إلى واقع ملموس.
نماذج التمثيل السياسي: إيطاليا والجزائر كأمثلة على “الدوائر الخاصة”
تعد إيطاليا والجزائر من أبرز الدول التي اعتمدت نظامًا فعالًا لضمان التمثيل السياسي لجالياتها. ففي إيطاليا، يتم تخصيص مقاعد برلمانية محددة للمواطنين المقيمين بالخارج، بحيث ينتخبون ممثليهم في دوائر انتخابية خاصة بهم. هذا النهج يضمن تمثيلا فعليا ومباشرا للجالية في البرلمان، حيث يمكن للنواب المخصصين لهم التركيز بشكل كامل على الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم دون الحاجة إلى التنافس مع مرشحي الداخل. وبالمثل، خصصت الجزائر 8 مقاعد للمهاجرين في برلمانها، من بينها 4 مقاعد مخصصة للجالية الجزائرية في فرنسا. هذه المقاربة تضمن أن تكون هناك أصوات ثابتة في البرلمان مخصصة للدفاع عن مصالح الجالية، وهو ما يعزز من شعورها بالانتماء والمشاركة الفعلية في القرار الوطني.
نماذج تعبئة الكفاءات: الدروس المستفادة
لقد أدركت العديد من الدول المضيفة أن “هجرة الأدمغة” هي في الواقع “ربح” لها، واستثمرت في جذب الكفاءات من دول مثل المغرب. في المقابل، تسعى دول مثل المغرب إلى استعادة هذه الكفاءات من خلال برامج رسمية. يمكن للمغرب أن يتعلم من هذه التجارب في كيفية بناء شبكات دائمة للكفاءات، وإطلاق برامج إرشاد (mentorship) تتيح للخبراء في الخارج نقل خبراتهم إلى الداخل، وتسهيل عودة الأدمغة عبر مسارات مهنية واضحة ومحفزات مالية حقيقية.
رؤى متعمقة: دور الجالية في التأطير الذاتي
إن الجاليات الوطنية، حتى في ظل غياب أو ضعف العلاقة الرسمية مع وطنها الأم، تمتلك قدرة هائلة على التنظيم الذاتي والعمل المدني. فعلى سبيل المثال، قامت الجاليات السورية في فرنسا بتأسيس مجالس إدارة منتخبة في أجواء ديمقراطية حقيقية لتمثيل أبناء جلدتها في المهجر. هذه التجربة تثبت أن الجالية المغربية تمتلك بدورها هذه القدرة على التنظيم الذاتي والعمل المدني والديمقراطي. يمكن للمغرب أن يستفيد من هذه القدرة على التنظيم عبر إشراك هذه الشبكات والمنظمات الأهلية في رسم السياسات وتطبيقها، بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع مؤسسات رسمية.
توصيات ومقترحات: نحو رؤية متجددة للمشاركة السياسية والاقتصادية
بناءً على التحليل السابق، يتضح أن تحقيق شراكة استراتيجية مع المغاربة المقيمين بالخارج يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الإصلاح القانوني، والتحفيز الاقتصادي، وبناء الثقة المؤسساتية. فيما يلي مجموعة من التوصيات المقترحة:
مقترحات لتفعيل الحق السياسي
- اعتماد نظام الدوائر الانتخابية الخاصة بالجالية: يجب تعديل القانون الانتخابي لتخصيص دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب على غرار التجربتين الإيطالية والجزائرية. هذا الإجراء سيضمن تمثيلًا حقيقيًا يدافع عن قضاياهم بشكل مباشر.
- إلزام الأحزاب بترشيح فعلي: في حال عدم إقرار دوائر خاصة، يجب فرض “كوتا” إلزامية في اللوائح الوطنية، مع إلزام الأحزاب بوضع مرشحين من الجالية في “مواقع متقدمة” تضمن فوزهم الفعلي، وليس فقط لإتمام نصاب للحصول على الدعم العمومي.
مقترحات لتحفيز الاستثمار
- إطلاق “صندوق استثمار” مخصص للجالية: يجب إنشاء صندوق استثمار مخصص، مدعوم بحوافز ضريبية وائتمانية مغرية، لزيادة نسبة الأموال المخصصة للاستثمار من 10% إلى مستويات تضاهي التجارب الدولية.
- تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية: يجب إطلاق “نافذة رقمية موحدة” وشاملة لجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، مع توفير آليات دفع إلكترونية، لتبسيط المساطر وتوفير الوقت والجهد.
- إشراك الكفاءات في المشاريع الكبرى: يجب إشراك الكفاءات المغربية في المشاريع التنموية الكبرى ذات القيمة المضافة، مثل الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الحديثة، من خلال برامج واضحة تضمن الاستفادة من خبراتهم.
مقترحات لإعادة هيكلة المؤسسات وبناء الثقة
- إصلاح جذري لمؤسسات الجالية: يجب إعادة النظر في هيكلة ومهام المؤسسات المعنية بقضايا الجالية، مثل مجلس الجالية، ليصبح هيئة فعالة وشفافة، ذات صلاحيات واضحة ومسؤولية حقيقية، وليس مجرد مجلس استشاري.
- رقمنة شاملة للخدمات القنصلية: يجب رقمنة جميع الخدمات القنصلية بشكل كامل، مع توفير آليات دفع إلكترونية فعالة ومتاحة، ونظام لمتابعة الشكاوى بشكل شفاف وفعال.
- بناء قنوات اتصال وتشاركية دائمة: يجب إقامة قنوات اتصال وتشاركية مستمرة ومباشرة بين الجالية ومؤسسات القرار، بما يضمن الاستماع إلى صوتهم وأخذ آرائهم في السياسات العامة التي تمسهم.
خلاصة: من النظرة “النفعية” إلى الشراكة “المواطنة”
في الختام، يظهر التحليل أن المغاربة المقيمين بالخارج ليسوا مجرد “خزانا ماليا” أو “سياحا” يزورون وطنهم لقضاء عطلة الصيف. إنهم يمثلون قوة حقيقية، رأسمالا بشريا واقتصاديا يمكن أن يكون رافعة حقيقية للتنمية. تكمن الإشكالية الرئيسية في أن الإطار الدستوري المتقدم لم يترجم بعد إلى آليات قانونية وسياسية كافية تضمن تمثيلا فعالا وتفتح آفاقا أوسع لاستثمار خبراتهم وكفاءاتهم. إن المعضلة ليست في المبدأ، بل في التطبيق.
إن الطريق نحو شراكة استراتيجية متكاملة يتطلب تبني رؤية جديدة، تعتبر الجالية شريكا كاملا في القرار والتنمية. هذا النهج يتطلب ليس فقط إصلاحات قانونية، بل تغييرا في الذهنية وفي طريقة تعامل المؤسسات مع المغاربة في الخارج. إن الاستماع إلى أصواتهم، وتبسيط حياتهم الإدارية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وضمان تمثيلهم السياسي الفعلي، كلها خطوات أساسية لترجمة العلاقة من مجرد نظرة “نفعية” إلى شراكة “مواطنة” حقيقية، وهي السبيل الوحيد للاستفادة الكاملة من طاقات المغاربة في الخارج، وضمان استدامة علاقتهم بوطنهم الأم.